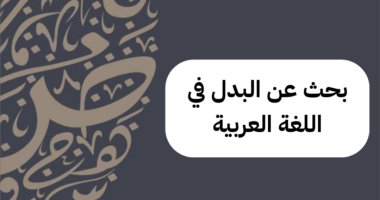تُعد اللغة العربية واحدة من أبرز اللغات من حيث الغنى والثراء وعند البحث في أصولها ستجدها كالبحر عطاؤها لا ينضب إذ تحتوي على قواعد نحوية متعددة وبلاغة تفوق غيرها من اللغات لذلك يُطلق عليها لغة الضاد ومن هذا المنطلق تبرز أهمية معرفة البدل في اللغة العربية لما يضفيه من لمسات تعبيرية مميزة ويظهر في العديد من المواضع في القرآن الكريم بأشكال مختلفة تعزز المعنى وتمنحه عمقًا وقوة في إيصال الفكرة.
البحث في مفهوم البدل في اللغة العربية
البَدَل في اللُّغة العربيّة يُعدّ أحد التوابع الَّتي تتبع ما سبقها مُباشرة دون وجود فاصل وقد مرّ هذا المصطلح بالعديد من التّطورات حتّى استقرّ عند النّحاة بعد نقاشات استمرّت لسنوات طويلة ففي البدايات كان يُعرف بأسماء مُختلفة مثل التَّرجمة والتَّبيين ولم يكن هناك تمييز واضح بينه وبين عطف البيان ولكن مع تطوّر الدراسات النّحويّة أصبح الفرق بينهما محدّدًا ومعروفًا.
المعنى اللغوي والاصطلاحي للبدل
- يذكر ابن منظور أن البديل هو ذاته البدل وعند قولك بدل الشيء فإنك تعني غيره ويقال أبدال لجمع البدل..
- التبديل يُشير إلى تغيير الشيء عن وضعه الأصلي بينما الإبدال فمعناه وضع شيء مكان آخر.
- يُوضّح الزجّاجي في تفسيره لآية “يوم تُبدل الأرض غير الأرض والسموات” أن المقصود – والله أعلم – هو تبدّل هيئة الأرض من خلال إزالة الجبال وتفجير البحار وتغيير معالمها.
- يرى أبو العباس أن التبديل الحقيقي يحدث عند تحويل الشيء إلى صورة أخرى تمامًا كما في قول “أبدلت الخاتم بالحلقة” أي أنك قمت بصهر الخاتم وصنعته على هيئة حلقة جديدة.
- وفي الاصطلاح يُعرف البدل بأنه أحد التوابع التي تأخذ الحكم مباشرة دون أي وساطة وهو من التوابع التي تتبع المتبوع في العديد من المواضع.
- من أهم المواضع التي يتبع فيها البدل المتبوع الإعراب والإفراد والتثنية والجمع ولهذا السبب يتكون التابع من قسمين أساسيين الأول المبدل منه أو المتبوع وهو الكلمة التي تسبق البدل والثاني هو البدل الذي يكون تابعًا للمتبوع.
إشكالات حول استخدام البدل
- لم يكن لدى النحويين في الفترات القديمة مصطلح موحد لتعريف البدل، فالمصادر النحوية أظهرت تنوعًا في التسمية، إذ أطلق عليه ثعلب مصطلح “ترجمة” مستشهدًا بالآية الكريمة “فذلك يومئذ يوم عسير” موضحًا أن “يومئذ” مرفوع و “يوم عسير” ترجمة له، وكان هذا المصطلح رائجًا بين علماء الكوفة.
- من جهة أخرى، أطلق الأخفش عليه اسم “ترجمة وتبيين”. بينما ذهب ابن كيان إلى تسميته بـ”التكرير”. أما المدرسة البصرية فلم يكن لديها إجماع واضح حول مصطلح محدد، فقد رأى سيبويه أن عطف البيان يُعدّ من أنواع البدل، إلا أن النحاة اللاحقين ميزوا بينهما معتبرين أن هناك تشابهًا فقط دون تطابق كامل.
- لاحقًا، جاء ابن مالك وقدم تعريفًا دقيقًا للبدل قائلًا إنه “التابع الذي يرتبط بالمبدل منه في المعنى دون وساطة”، مما جعله يحدد مفهوم البدل بشكل واضح، حيث لم يدخله ما ليس منه ولم يستثنِ منه ما ينبغي أن يكون ضمنه.
( الصورة دي عليها كلمة المناهل لو تقدر تشيلها يا نصر )
العناصر الأساسية للبدل في اللغة العربية
عند الحديث عن البدل في اللغة العربية نجد أن له عنصرين رئيسيين هما المبدل منه والبَدل ولا يوجد بينهما أي أداة ربط مثل حروف العطف كما في قولنا “مررت بأخيك عوف” حيث تعد كلمة “عوف” بدلاً من “أخيك” أي أنها تشير إلى الشخص نفسه دون وجود أي أداة تربط بينهما مثل حروف العطف.
بهذا التوضيح تمكن علماء اللغة المعاصرون من تقديم تعريف أكثر دقة للبدل على أنه “تابع يدل على نفس المعنى الذي سبقه أو على جزء منه ويكون مقصودًا بذاته دون وجود أداة ربط” وهذا ما يجعله متميزًا عن النعت والتوكيد إذ إنه يُراد لذاته مما يعني أن حذفه من الجملة لا يؤثر على معناها كما أنه يختلف عن العطف لعدم حاجته إلى أداة وصل تربطه بالمبدل منه.
تصنيفات البدل وأبرز أنواعه
يتم تصنيف البدل إلى عدة أنواع رئيسية، ومن أبرزها:
بدل كل من كل
- يُعرف هذا النوع بأن البدل يُطابق المبدل منه تطابقًا تامًا في المعنى.
- من الأمثلة على ذلك: “حضر الطبيب أحمد”، حيث نجد أن “أحمد” يعبر عن نفس الشخص الذي يشير إليه “الطبيب”، أي أن البدل يُعبر عن المسمى ذاته.
- كما ورد في القرآن الكريم: “اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ”، ففي هذه الآية نجد أن “صراط الذين أنعمت عليهم” هو بدل عن “الصراط المستقيم”، وأيضًا في قوله تعالى: “إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا”، حيث جاءت “حدائق” بدلًا عن “مفازًا”.
بدل بعض من كل
- يشير هذا النوع إلى أن البدل يُعتبر جزءًا من المبدل منه سواء كان هذا الجزء يمثل نسبة صغيرة أو كان مساويًا لنصفه أو أكثر.
- من الأمثلة على ذلك: “أكلت التفاحة نصفها”، حيث نجد أن “نصفها” هو البدل، لأنه جزء من “التفاحة”.
- كما ورد في قوله تعالى: “وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا”، فنلاحظ أن “من استطاع” بدل عن “الناس”، حيث يشير إلى بعضهم وليس جميعهم.
بدل الاشتمال
- يتميز هذا النوع بأن البدل يكون أمرًا مرتبطًا بالمبدل منه لكنه لا يُعد جزءًا ماديًا منه.
- يُعرّفه اللغويون بأنه دلالة على معنى يخص المبدل منه لكنه غير مُنفصل عنه فكريًا.
- من الأمثلة الواضحة على ذلك: “أعجبت بالكاتب أسلوبه”، حيث نجد أن “أسلوبه” هو البدل، لأنه يتصل بـ”الكاتب” ولكنه ليس جزءًا منه من الناحية المادية، وكذلك في الجملة: “أكرمت المعلم أخلاقه”، حيث تشير “أخلاقه” إلى إحدى الصفات التي يتميز بها “المعلم”.
دراسة حول البدل المباين ومفهومه
يعتبر البدل المباين من الأنواع التي نادرًا ما تُستخدم في اللغة العربية وعندما يظهر في الكلام يُستخدم غالبًا مع أداة الاستدراك “بل” لتوضيح أن هناك تصحيحًا أو تعديلًا في المقصود من الجملة وينقسم هذا النوع من البدل إلى ثلاثة أنواع رئيسية.
بدل الإضراب
- يُستخدم هذا النوع عندما يكون كل من البدل والمبدل منه لهما نفس المعنى في الجملة أي أن القصد منهما متساوٍ وقد وضح مصطفى الغلاييني أن بدل الإضراب قائم على أن كلا الكلمتين المذكورتين تحملان المقصود ذاته.
- على سبيل المثال: “نجح محمد عليّ” حيث تدل الجملة على أن النجاح قد تحقق لكلا الاسمين المذكورين أي أن النجاح يشمل الاثنين وليس أحدهما فقط.
بدل الغلط
- يظهر هذا النوع عندما يتم ذكر كلمة بشكل غير مقصود في البداية ثم يتم تصحيحها بالكلمة الصحيحة التي تأتي بديلًا عنها ويُلاحظ أن هذا النوع لا يُستخدم في النصوص القرآنية أو الشعر بل يكثر في المحادثات اليومية والتعبيرات العفوية.
- مثال على ذلك: “رأيت عمرًا داره” حيث كان المقصود الفعلي هو “داره”، بينما الكلمة الأولى “عمرًا” لم تكن تعبر عن المعنى المراد.
بدل النسيان
- يحدث هذا النوع عندما يذكر المتحدث كلمة في البداية ثم يتبين له لاحقًا أن هناك خطأ فيما قاله فيصححه بذكر كلمة أخرى صحيحة ويحدث ذلك غالبًا نتيجة السهو أو عدم التركيز.
- مثال ذلك: “سافر أحمد إلى القاهرة الإسكندرية” حيث تم ذكر “القاهرة” أولًا ثم تبيّن أن الوجهة الصحيحة هي “الإسكندرية” فحلت الكلمة الأخيرة كتصحيح للخطأ الذي ورد في البداية.
الضوابط الحاكمة لاستخدام البدل
البدل يُلازم المُبدل منه من حيث الإعراب لأنه واحد من التوابع التي تكتسب إعراب ما يسبقها سواء أكان مرفوعًا أو منصوبًا أو مجرورًا لكن في بعض المواضع يخرج عن هذا النمط ولا يُطابقه بشكل تام مثل:
- قواعد التذكير والتأنيث: قد لا يلتزم البدل بنفس النوع النحوي من حيث التذكير والتأنيث كما يحدث في بدل الاشتمال أو بدل الغلط مثل في الجملة: “أعجبني فاطمة أدبها” حيث نجد أن “فاطمة” اسم مؤنث وهي المُبدل منه في حين أن “أدبها” مذكر وهو بدل اشتمال.
- التمييز بين النكرة والمعرفة: في بعض الأحيان يظهر البدل في صيغة نكرة رغم أن المُبدل منه يأتي في صورة معرفة كما ورد في قوله تعالى: *”كلا لئن لم ينته لنسفعًا بالناصية ناصيةٍ كاذبةٍ خاطئةٍ”*. فقد جاءت كلمة “بالناصية” باعتبارها معرفة إلا أن البدل جاء في صورة نكرة وهو “ناصيةٍ”.
- اتساق التعريف والتنكير: في بعض التراكيب اللغوية يكون البدل مُعرفًا بينما المُبدل منه يأتي في صيغة نكرة كما هو الحال في قوله تعالى: *”وإنك لتهدي إلى صراط الله”*. فقد جاءت “صراط” نكرة لكن تم الاستعاضة عنها ببدل معرفة وهو “الله”.
مواضع ورود البدل في التراكيب اللغوية العربية
عند الحديث عن مواضع ورود البدل في التراكيب اللغوية العربية نجد أن استخدامه يتطلب مراعاة طبيعة العلاقة بين الاسم المستبدل والبديل عنه حيث تتعدد الحالات التي يمكن فيها إحلال الاسم الظاهر محل اسم ظاهر آخر بينما إذا كان الاستبدال يشمل الضمير فإن ذلك يخضع لاعتبارات دقيقة ومن أبرز هذه الحالات:
- حين يكون البدل من نوع “كل من كل” بحيث يشمل المعنى كاملاً كما في المثال “تكون لنا عيدًا لأولنا وآخرنا” فهنا نجد أن كلمة “أولنا” جاءت بدلًا من الضمير “لنا” بوصفها تعبر عن الجزء المستبدل منه بالكامل.
- عند ورود بدل الاشتمال في الجملة كما في قولنا “وما ألفيتني حلمي” إذ نجد أن “حلمي” وقع بدل اشتمال لياء المتكلم في “ألفيتني” حيث يشير إلى أحد خصائص المتكلم أو صفاته التي يتضمنها الضمير.
- إمكانية ورود البدل على هيئة جملة تستبدل بمفرد أو العكس كما في عبارة “لا إله إلا الله كلمة الإخلاص” فنجد أن “كلمة الإخلاص” تشكل بدلًا مرفوعًا عن الجملة “لا إله إلا الله” مما يؤكد أن الجملة الأصلية يمكن استبدالها بمفرد يؤدي معناها بصورة مباشرة.
- عند مجيء البدل عقب اسم استفهام يقتضي ذلك إضافة همزة الاستفهام إلى الجملة كما هو الحال في السؤال “من ذا؟ أمحمد أم زيد؟” حيث نستعين بالهمزة عند ذكر البدل لتوضيح المراد منه.
- يمكن أن يأتي البدل في صورة فعل يتم استبداله بفعل آخر كما في المثال “من يصل إلينا يستعن بنا” وكذلك نجده في النص القرآني “ومن يفعل ذلك يلق أثامًا” حيث ورد الفعل “يلق” بدلًا من “يفعل”.
- عند ارتباط البدل باسم الشرط يستوجب الأمر إضافة “أن الشرطية” مع البدل كما في “من يجتهد إن محمد وإن صلاح فأكرمه” إذ جاءت “إن محمد وإن صلاح” بمثابة بدل مرتبط بشرط يتطلب التفسير.
التمييز بين عطف البيان والبدل
عطف البيان لا يأتي في صورة ضمير ويقتصر على المفرد بينما يمكن للبدل أن يأتي على صورة ضمير أو أن يكون تابعًا للمفرد وغيره. يجب أن يتطابق عطف البيان مع متبوعه في التعريف أو التنكير في حين أن البدل ليس شرطًا أن يكون مطابقًا له. عطف البيان لا يكون فعلًا تابعًا لفعل بينما يمكن أن يكون البدل كذلك. البدل يُعد هو المعني بالحكم بينما الغاية من عطف البيان هي توضيح التابع دون أن يكون هو الأساس في الجملة.
التوسع في دراسة البدل يُظهر مدى جمالية اللغة العربية ويكشف عن عمقها وبلاغتها في مختلف تراكيبها وأقسامها فاللغة العربية تمتاز بتعدد قواعدها التي تتيح للقارئ استيعاب المعاني بطريقة دقيقة كأنه يتأمل لوحة فنية نابضة بالحياة وهذا ما يحرص عليه الأدباء وأهل البلاغة الذين يستخدمون الكلمات البليغة لرسم المشهد بأسلوب يُحاكي الذهن ويعزز فهم المعاني ويجسّد روعة التعبير العربي.